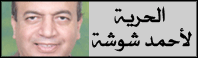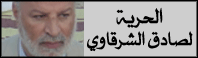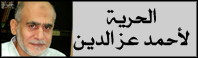وثانيها: يتعلق بتوقيته
وثالثها: يتعلق بطبيعته
ورابعها: يتعلق بدلالاته وتأثيراته المحتملة علي مستقبل الحياة السياسية في مصر،
فالحكم صدر عن أحد أركان النظام القضائي الأساسية في مصر وهو مجلس الدولة، والذي يفترض قيامه بدور مكمل لدور المحاكم الدستورية العليا باعتباره إحدي الجهات المخولة بضبط أداء السلطة التنفيذية وضمان عدم تعسفها في استخدام صلاحياتها،
خاصة ما يتعلق منها بإدارة شؤون العباد وأحوالهم، وصدر في توقيت بالغ الحساسية يتسم بحالة استقطاب حادة تشهدها الحياة السياسية والاجتماعية في مصر وتثير شعورا بالقلق علي مستقبل البلاد ومصيرها، ولأن الحكم يتعلق بموضوع يريد البعض إظهاره ماساً بأمن الدولة ويمثل تحديا شخصيا لرئيسها، فمن المتوقع أن تكون له نتائج سياسية بعيدة المدي.
إن إقدام جهة قضائية في ثقل مجلس الدولة علي إلغاء قرار اتخذه رئيس الدولة بنفسه في موضوع علي هذه الدرجة من الخطورة وفي توقيت علي هذا القدر من الحساسية، ليس بالحدث العادي الذي يمكن أن يمر بلا أثر، ففي تقديري أنه سيكون لهذا الحدث تداعيات مهمة ستبقي معنا لفترة طويلة قادمة سواء امتثلت له الحكومة ونفذته أم لم تمتثل له وقررت تحديه.
فامتثال الحكومة له سيقوي موقف جماعة الإخوان وقوي المعارضة في مواجهتها، وعدم امتثالها له سيزيد حالة الاحتقان القائمة سوءاً، وربما يقترب بها من نقطة الانفجار، وفي كلا الحالتين ستخسر الحكومة والنظام وربما المجتمع ككل، وما لم يبادر الجميع ببذل جهود مخلصة للخروج من الحلقة الجهنمية التي أوقعتنا فيها حالة عناد مرضية تتسم بها تصرفات الحزب الوطني، فليس أمامنا سوي انتظار مصير مجهول ومخيف.
ليس في نيتي هنا مناقشة الحيثيات التي استند إليها الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداري، غير أن تعليقات سمعتها من بعض المنتمين إلي لجنة السياسات علي بعض القنوات الفضائية، ترفض الحكم وتجرحه باعتباره مخالفا لنصوص دستورية وقانونية صريحة، تتطلب وقفة سريعة قبل أن ندلف إلي جوهر الموضوع.
ومن نافلة القول إنه لم يكن خافيا علي محكمة القضاء الإداري أن لرئيس الدولة صلاحيات واسعة تعطيه الحق في إحالة ما يراه من قضايا إلي المحاكم العسكرية، ورغم أن المتخصصين في الدراسات السياسة من أمثالي يميلون إلي عدم الاعتراف أصلا بشرعية أي سلطة تمنح لأي حاكم مستبد حصل علي مقعده بالقوة أو عبر عملية انتخابية مشكوك في نزاهتها،
إلا أن رجال القانون يتعاملون مع أمور كهذه بمنطق أكثر حصافة، فهم يدركون إدراكا واعيا أن مهمتهم تنحصر في تطبيق الدستور والقانون، بصرف النظر عن رأيهم الشخصي فيما يمكن أن يكون قد شابهما من عورات تشكك في شرعيتهما!.
وهنا يثور سؤال مهم: ما الركيزة القانونية التي استند إليها القضاء الإداري للحكم بإبطال قرار لرئيس دولة يعطيه الدستور والقانون صراحة، لا ضمنا أو اجتهادا، حق إحالة ما يراه من قضايا لمحاكم عسكرية وليس مدنية، الإجابة التي يتعمد أنصار لجنة السياسات إغفالها تبدو بديهية ولا تحتاج لفطنة كبيرة.
فالدستور والقوانين التي خولت رئيس الدولة صلاحية الإحالة للمحاكم العسكرية هي ذاتها التي كفلت لأي مواطن يتهم حق المثول أمام قاضيه الطبيعي، وحين يتعين علي القاضي النظر في قضايا تضع أصحاب الحقوق في مواجهة أصحاب السلطان،
مثلما هو الحال في القضايا التي تعرض عادة علي مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، تصبح مهمته الأولي التأكد من عدم تعسف صاحب السلطة في ممارستها ضمانا لحصول صاحب الحق علي حقه، وتلك سلطة تقديرية يمنحها الدستور والقانون للقاضي وليس للحاكم الذي يتحول إلي خصم في مثل هذه الحالات.
والحكم الذي أصدره القضاء الإداري ببطلان قرار رئيس الجمهورية بإحالة متهمين من جماعة الإخوان إلي محاكم عسكرية، بدلا من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي لم يعطل قانوناً ولم يخالف نصاً دستورياً واعتبر أن رئيس الدولة استخدم السلطة الممنوحة له في غير موضعها وبطريقة ألحقت ضرراً بمواطنين حين أنكرت عليهم حقا يكفله لهم الدستور ومن ثم وجب رفع الضرر وإعادة الحقوق لأصحابها.
ولأن وضع رئيس الجمهورية، في مواجهة مواطنيه أمام مجلس الدولة، لا يختلف عن وضع رئيس أي دائرة حكومية في مواجهة مرؤوسيه، فمن الطبيعي أن يكون للقاضي سلطة إبطال أي قرار إداري يري فيه مصادرة علي حق يكفله القانون لأحد أو يلحق ضررا لا يجيزه القانون لأحد، حتي ولو كان صادراً عن رئيس الدولة نفسه، ولهذا يمكن القول إن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بإبطال قرار رئيس الجمهورية بإحالة مواطنين إلي محكمة عسكرية هو حكم يتسق نصاً وروحاً مع صحيح القانون.
لكن لندع حبائل القوانين ودهاليزها لمن هم أكثر منا علما وخبرة، ولننتقل الآن إلي الجانب الأهم في رأينا وهو الدلالات السياسية لهذا الحكم التاريخي وتأثيراته المستقبلية المحتملة، وفي تقديري أنه ما كان لحكم كهذا، والذي يضع مجرد صدوره رئيس الدولة في حرج بالغ حتي ولو تم إلغاؤه لاحقا بقرار من المحكمة الإدارية العليا، لولا حالة الاستقطاب الحادة التي تمر بها البلاد الآن.
ففي الأحوال العادية يعمل القضاء علي النأي بنفسه بعيدا عن القضايا ذات الأبعاد والحساسيات السياسية، كأن يحكم بعدم الاختصاص أو يبحث عن وسائل لتهدئة الأجواء، بالتأجيل أو حتي بالتسويف، إذا رأي أن المصلحة العامة تقضي بذلك، أما في حالات الاحتقان والاستقطاب فيصبح وضع القضاء صعبا جدا وحساسا،
لأن الحكم بعدم الاختصاص في قضايا بعينها، أو تأجيلها تسويفا أو كسبا للوقت، قد يفسر علي أنه ينطوي علي تواطؤ صريح في جريمة تصفية حسابات سياسية لا سند لها ولا مبرر من القانون، ولا استبعد شخصيا أن يكون اعتبارا كهذا قد ورد علي ذهن طاقم القضاة الذين أصدروا الحكم وأن يكون هو الذي حسم الموقف في النهاية.
وإذا صح هذا الاستنتاج فلن يكون له سوي معني واحد وهو أن شرائح مختلفة ومهمة من النخبة السياسية بدأت تعي خطورة حالة الاستقطاب السياسي الراهنة وتدرك أن عليها واجب التحرك، كل بطريقته الخاصة وبالأسلوب الذي يتواءم مع طبيعة عمله ودوره، لتجاوزها وإنقاذ البلاد من مصير مجهول يتربص بها.
بل إنني لا أستبعد مطلقا أن تكون شرائح أخري من النخبة، بما في ذلك الشرائح الأكثر طاعة للنظام والتصاقا به، قد بدأت تفكر بالطريقة ذاتها، وهو ما قد يعني أن عملية الحراك السياسي الذي تشهده البلاد منذ سنتين أدي إلي ما يكفي من التراكم لإحداث نقلة نوعية ينتظرها كثيرون.
وأيا كان الأمر، فقد بات واضحا للجميع الآن أن الحزب الحاكم قرر افتعال مواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين ليس لها ما يبررها سوي رغبته في الحصول علي دعم وتأييد القوي المناهضة لتيار الإسلام السياسي، خاصة اليمين الليبرالي واليسار الماركسي، للخروج من حالة استقطاب سياسي تضعه وحيدا في مواجهة الجميع.
لكن المشكلة أن الحزب الحاكم ليس لديه ما يقدمه لأي طرف، سواء ليمين ليبرالي أو ليسار ماركسي، وذلك لسبب بسيط وهو أنه لا يرغب في تقاسم السلطة أو الثروة مع أحد، فإصرار هذا الحزب علي احتكار السلطة وربما توريثها يضعه في تناقض تام مع يمين ليبرالي معرض، لأن يفقد كل ما تبقي من مصداقيته،
حتي ولو حاول تصوير موقفه علي أنه عمل تكتيكي يستهدف الحصول علي مكاسب مرحلية تدعم ثقله في المجالس المحلية والنيابية، وإصراره علي احتكار الثروة، يضعه في تناقض تام مع يسار ماركسي معرض، لأن يفقد كل ما تبقي من مصداقيته إن هو تحالف مع نظام يجسد تحالف الاستبداد والفساد في أشد صورهما بدائية، وذلك بدعوي قطع الطريق علي الدولة الثيوقراطية!.
في سياق كهذا ليس هناك من حل في نظري لتجاوز مرحلة الاستقطاب الراهنة سوي العمل علي استيعاب تيار الإسلام السياسي داخل نظام سياسي يتجه إلي إرساء قواعد ديمقراطية حقيقية.
فهل يساهم هذا الحكم التاريخي الشجاع في إقناع النظام بضرورة التخلي عن حالة العناد المرضي التي تستبد به الآن ويضع خريطة طريق لعملية تحول ديمقراطي، أم أنه سيظل سادرا في غيه مصرا علي خوض المعركة بمنطق أنا ومن بعدي الطوفان، أظن أن الاحتمال الآخير هو الأرجح. ولذلك فإن شرائح المجتمع كله، وليس القضاة وحدهم، مطالبون بالتحرك لتشكيل جبهة موحدة للإنقاذ
0 التعليقات :