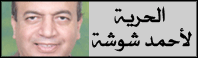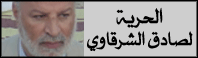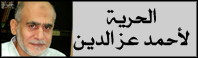في ليلةٍ من الليالي التي أراها أنها لا تستوي وأنا أتهيأ للنوم بعد أن فرغت من صلاة ركعتين إذْ يُغشيني النعاس أمنةً من ربي مثلي مثل إخواني في القضية (2 عسكرية) ونحن لا ندري ما يُخبِّئ لنا القدر، ولكن كما نعتقد ونؤمن أنَّ قدرَ الله لنا كله خير، إذا بي أستيقظ على صوتي وأنا أقول "نعم، إن شاء الله" وأكررها ثلاثًا فابتسمتُ وقلتُ لنفسي مَن الذي حملني على أن أقول هذه الجملة فإذا بي أجد نفسي تقول خيرًا أعد ما حدث قبل هذه الجملة فعلمتُ أني قد رأيتُ رؤيا أنني في جلسة مع بعض الإخوة دار فيها حديث حول الأوضاع المتردية التي وصلت إليها الأمة، وبعد أن أدلى كل منهم بدلوه في الموضوع قال أحدهم: ما الحل؟
أليس لهذا الليلِ من آخر؟
قال أحد الإخوة وكنتُ أجلس بجواره: أو تريد الحل؟
قال: نعم.
قال مَن بجواري وقد بدأ الحديث يأخذ شكل الحوار: الحل قريب قريب وبعيد بعيد.
قال أخ آخر: ما هذا أحجية أم لغز؟
قال مَن بجواري: لا أحجية ولا لغز.
قيل له: إذًا كيف يكون قريبًا وبعيدًا في آنٍ واحدٍ؟!
قال مَن بجواري: هو قريبٌ لأنه في متناول أيدينا، وبعيد طالما بقينا عازفين عنه.
قال الأخ الأول: هو في متناول اليد ونعزف عنه، ومع حاجتنا الماسة إليه؟!
قال مَن بجواري: نعم
قال مَن أجَّج هذا الحوار: كيف؟ ولماذا؟
قال مَن بجواري: لأننا جهلنا حقيقته.
قال له: وما هو بالله عليك؟
قال مَن بجواري: الحب.
قال الأخ الأول مستغربًا أي حب تعني هداك الله؟
قال مَن بجواري: للحب معنى أسمى وأعظم مما يفهمه الجاهلون إذْ ينحرفون به، ويشوهونه.
قيل له: وما هو هذا المعنى؟
قال: لقد اقترب منه أفلاطون إذْ عبَّر عنه بأنه قوة توطيد العلاقات بين المخلوقات.
- ومن أين لنا بهذه القوة؟ بل كيف تزعم أنها في متناول أيدينا؟!
- نستمدها من الخالق العظيم جل شأنه.
- وكيف يكون ذلك؟
- بحبه سبحانه وتعالى.
- ولكنك قلتَ بأن الحب هو توطيد العلاقات، فإذا كنا لا نملك قوة توطيد العلاقات مع المخلوقات فمن أين لنا بقوة توطيدها مع الخالق العظيم؟!
- إنَّ توطيدَ العلاقة مع الخالق العظيم أسهل وأيسر بكثيرٍ من توطيدها مع المخلوقات؛ ذلك لأن العلاقةَ مع الخالق العظيم يحكمها التفضل منه سبحانه وتعالى، بينما العلاقة مع المخلوقات يحكمها التفضل منها، أو على الأقل تحكمها المعاملة بالمثل، وشتَّان ما بين تفضل الخالق العظيم، المنعم الكريم، وتفضل المخلوق الهلوع، المنوع الجذوع.
- أرجو أن تشرح لي إذا سمحت.
- الخالق العظيم يُعطي ولا يأخذ، فهو سبحانه وتعالى في علاقته مع المخلوقات دائن دائمًا، والمخلوقات هي المدينة له جلَّ شأنه، أما المخلوق فيأخذ، وإذا أعطى فإنما يُعطِي بمقابل.
- زدني إيضاحًا.
- الخالق جلَّ شأنه أسبغ علينا نعمه ظاهرةً وباطنةً بفضلٍ منه سبحانه وتعالى، وهو لا يريد منا إلا الاعتراف بذلك وشكره- عزَّ وجل- على نعمائه، فإذا نحن شكرناه سبحانه وتعالى زادنا من فضله وكرمه، أليس هو القائل عز وجل: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (إبراهيم: من الآية 7).
- وكيف قلت إنَّ الله لا يأخذ وهو جل شأنه يقول: ﴿هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ (التوبة: من الآية 104)، ويقول سبحانه: ﴿فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ﴾ (الرعد: من الآية 32)، ويقول أيضًا: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ﴾ (التوبة: من الآية 111)، كما أن رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- قال: "لله ما أعطى ولله ما أخذ".
- أولاً: إن معنى الأخذ هنا مغاير للمعنى الأول الذي شرحته.
ثانيًا: إن الله حين يأخذ شيئًا لا يأخذه لنفسه؛ لأنه سبحانه وتعالى غنيٌّ عن العالمين، والكل له؛ فإذا أخذ شيئًا مما أعطى للمؤمن فذلك لمصلحةِ المؤمن؛ لأنه يُنميه له أضعافًا مضاعفةً بدليل قوله عز وجل: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261)﴾ (البقرة)، أو يعوضه عنه بما هو خير منه وأبقى، ففي سورة الكهف عندما أنكر سيدنا موسى عليه السلام على العبد الصالح قتل الغلام قال: ﴿وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81)﴾ (الكهف)، وحين اشترى سبحانه وتعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة، إنما اشترى أشياءً يملكها.. أليس هو خالق هذه الأنفس وممولها؟ فلو كان بحاجةٍ إليها وحاشاه أن يكون كذلك لما كان مضطرًا لأن يشتريها ما دام مالكها أصلاً، ولكنه جلَّت عظمته بعد أن تفضَّل عليها فوجدها أدَّت واجبَ الشكر أراد أن يزيدها من فضله وكرمه فيعطيها بدلاً مما يفنى ما هو خيرٌ وأبقى، هذا بالنسبة للمؤمن، أما الكافر فمن أسباب أخذ الله سبحانه وتعالى له إيذاؤه للمخلوقات الأخرى التي هي أولى بالرعاية منه، مثلما فعل العبد الصالح عليه السلام حين قتل الغلام رحمةً بأبويه المؤمنين وخشيةً عليهما من أن يُرهقهما طغيانًا وكفرًا، إنَّ وجودَ الكافر نشاز في نغم الانسجام العظيم بين المخلوقات جميعًا؛ لأن جميعَ المخلوقات تُسبِّح بحمد الله، قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ (الإسراء: من الآية 44).
أما الكافر فهو جاحدٌ لا يُسبِّح بحمد الله، أو مشرك يعبد من دون الله آلهةً أخرى، وبذلك لا يكون منسجمًا حتى مع نفسه؛ فكل عضو من أعضائه يُسبِّح الله سواء شاء هو أم أبى، وسواء أحب هو أو كره، بل إنَّ أعضاءه تُظهر عداءها له يوم القيامة وبراءتها منه، فتشهد عليه بما اقترفَ بها من آثامٍ.. قال تعالى في سورة النور: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24)﴾؛ لذلك فإذا أراد الله أن يرحم المخلوقات من شغبِ الظالم، وإذا تفضَّل عليها بتخليصها منه فأخذه.
- آمنَّا بأن الله تعالى يُعطي، وإذا أخذ جلَّ جلاله فإنما يأخذ لحكمةٍ فيها مصلحة للخلق، وسلمنا بأنَّ توطيدَ العلاقة معه سبحانه وتعالى أسهل وأيسر من توطيدها مع المخلوقات، وهذا منطقي لا جدالَ فيه.
- وأين الجدال إذًا؟
- الجدال في أننا بالرغم من ذلك لا نجد هذه العلاقة متوطدة في الواقع فلماذا؟ ما دامت أسهل وأيسر وأجدى؟
- ذلك لأننا غافلون عن هذه الحقيقة، لا أقول كلنا، بل أكثرنا وغفلة أكثرنا هذه جعلتنا معرضين عن الله سبحانه وتعالى وهو جل شأنه يقول: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾ (طه: من الآية 124) وهذا أصل البلاء، وسبب المشاكل التي نطلب لها الحل، لقد ظلم أكثرنا أنفسهم بإعراضهم عن ذكرِ الله فاجتاحتنا الفتن؛ لأن الله- عزَّ وجلَّ- يقول: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (الأنفال: من الآية 25)، ويا ليتها فتنة واحدة رجعنا بعدها إلى الله عملاً بقوله عز وجل: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21)﴾ (السجدة)، ولكننا مع الأسف لم نرجع ولم ننتبه من غفلتنا حين أصابتنا الفتنة فاستمرَّ الإعراض عن ذكرِ الله واستمرَّ معه تتابع الفتن حتى صارت كما قال رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: "بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم، يُصبح الرجلُ مؤمنًا ويُمسي كافرًا، ويُمسي مؤمنًا ويُصبح كافرًا، يبيع دينه بعرضٍ من الدنيا" (رواه مسلم والترمذي وأحمد).
- وهل أصبح الأمر مستحيلاً أو ميئوسًا منه؟
- أبدًا فما هو بمستحيل ولا ميئوس منه بل هو سهل ميسر إذا أردناه مخلصين إنه لا يحتاج منا إلا الإقبال بصدقٍ على الله والإعراض بحقٍّ وحزمٍ عمن سواه، ولا يكون ذلك إلا بالحبِّ الصادق الذي لا يكون له به مكان في قلوبنا لغير الله، وصدق الله العظيم القائل: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ (الأحزاب: من الآية 4).
ولا مجالَ للمقارنةِ بين حبنا للخالق العظيم، وحبنا لمخلوقٍ مثلنا؛ لأنَّ المخلوقَ قد يطمع في المحب فيستغله، أو يتمنع عنه فيضله أو يتحكَّم فيه فيذله، ونادرًا ما يقابله بحبٍّ فيعامله بالمثل أو بأقل منه.
أما الخالق سبحانه وتعالى فإنه يُحيط مَن يُحبه بحبٍّ أكبر وأعظم من حبه؛ مما يجعله بفضله منعمًا، وبقربه منه عزيزًا مكرمًا، ففي الحديث القدسي يقول الله- عزَّ وجل-: "أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر" (رواه مسلم).
ودليل الحديث القدسي من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)﴾ (السجدة) أليس هو القائل جلَّ شأنه في الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرَّب مني شبرًا، تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب إلي ذراعًا، تقربت منه باعًا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة" (رواه مسلم)، أليس هو القائل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: "مَن عادى لي وليًا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها" (رواه البخاري).
- أليس في الحديث القدسي كذلك "إذا أحب الله العبد نادى جبريل إنَّ الله يحب فلانًا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانًا، فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يُوضع له القبول في الأرض" (رواه البخاري).
وهكذا يكون للعبد من توطيدِ علاقته بالخالق العظيم قوة يُوطِّد بها علاقته بالمخلوقات.
- كيف؟
- إنَّ حب المخلوق لله سيجعله مطيعًا له، وسيظهر هذا في تصرفاته مع الناس فلا يعتدي على أحدٍ؛ لأنَّ الله لا يحب الظالمين، ولا يسعى في الأرض فسادًا؛ لأن الله لا يحب المفسدين، ولا يُسرف أو يبذر؛ لأنَّ الله لا يحب المسرفين، ولا يخون لأن الله لا يحب الخائنين، ولا يستكبر لأن الله لا يحب المستكبرين، كما أنَّ حرصه على حبِّ الله له يجعله يحسن؛ لأن الله يحب المحسنين، ويتوب ويتطهر؛ لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويفي بعهده ويتقي؛ لأن الله يحب المتقين، ويعفو ويصفح لأن الله يحب العافين المحسنين، ويصبر على البلاء والأذى؛ لأن الله يحب الصابرين، ولا شك أنَّ مَن كان هذا خلقه سيُحبه الناس.
- لذلك رأينا رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- يؤكد هذا المعنى يقول في الحديث: "لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم"، رواه مسلم.
- ولا ريب في أن إفشاء السلام يقتصر على التحية، وإنما يتعدَّى ذلك إلى كلِّ ما سبق ذكره من عدم الاعتداء، وعدم الظلم، وعدم الإفساد وعدم الاستكبار وعدم الخيانة، بالإضافةِ إلى الإحسان والوفاء بالعهد والتقوى، والعفو، والصفح والصبر.. إلى آخر ما هنالك من التصرفات التي يتحلَّى بها المؤمنون الصادقون، فإذا تمَّ ذلك تحقق السلام والأمن والأمان وعمَّ في ربوع الأرض الإسلام والرخاء وأكلوا من طيبات الله وفتح عليهم بركات من السماء والأرض.
- قال الحاضرون: نسأل الله أن يحقق ذلك.
- قال مَن بجوار منهيًا حديثه: فلنبدأ بأنفسنا؛ لأنَّ الله لا يُغيِّر ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم.
- قالوا: إنْ شاء الله.
- قلتُ: إنْ شاءَ الله.
---------------
* رؤيا سيد معروف- أحد الإخوان المحالين إلى المحاكمة العسكرية
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)